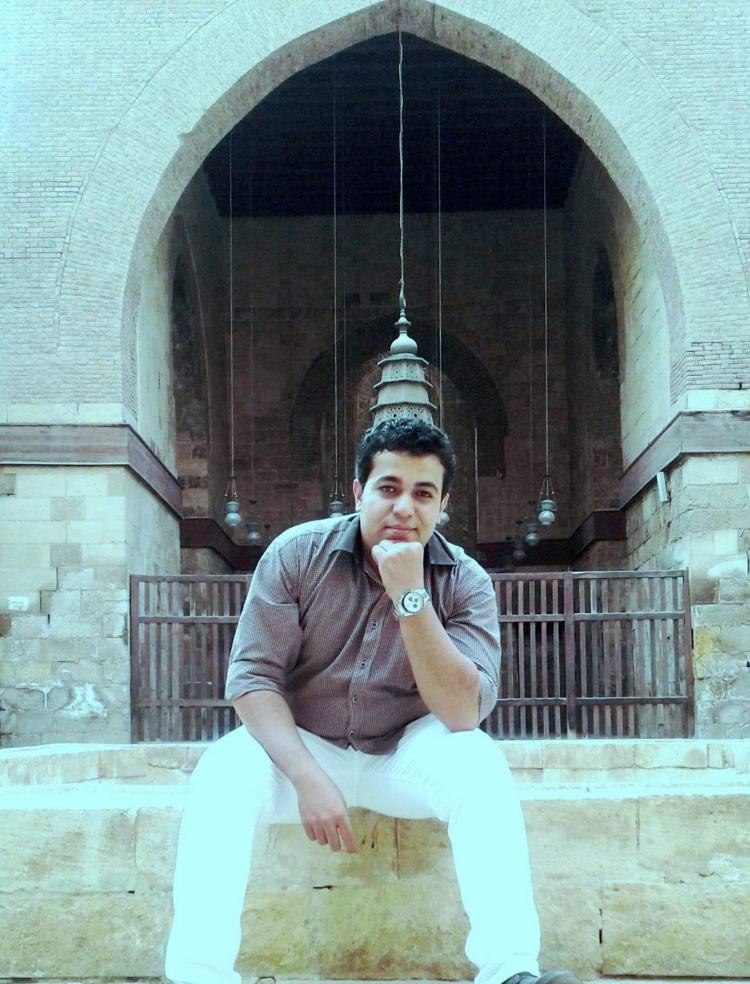بقلم: عبد الرحمن تمام
في حياة قديمة كنتُ عازف قيثار أينما توجّهتُ تركتُ شيئًا من أصدائي أذكرُ أنني غنيتُ للبُناة المهرة ولعمّال الأرض وللصيادين وهم يطرحون شباكهم في النهر كنتُ جميلًا مثل طلعةِ الشمس باهرًا.. أمشي في الطرقات وأنوس كسنابل الحقل لمّـا تهزّها يدُ الريح كأن الأناشيد كُلَّها حَبَّاتُ قمــحٍ وأنين المتعبين سافيةٌ رؤوم! ولكم ساءلتُ روحي صباحَ مساء: متى تحفن امرأةٌ من زرعِ هذا القلب فيطيب لها خبزًا؟! وذات مرّةٍ دُعيتُ إلى حفل فذهبتُ كي أداعب أوتاري وأُهيّجُ ، بأطراف أناملي، مواطن الأرواح ثم رأيتكِ_ يا محبوبتي وأختي_ هناك كنتِ وسط المدعوات تشبهين ظبيةً ساقها الحظُ السيء فنزلتْ بمكان معشوشب ترعى في جنباته قطعان ماعز هل تذكرين كيف نظرتُ إلى عينيكِ ليلتها؟ كيف تركتُ موائد الطعام والجعة وانسللتُ بكِ بعيدًا عن الأعين لأفرح بخمركِ وأطايبكِ وكيف تتبعتُ خطاكِ أنتِ ومَنْ معكِ حتى انتهينا إلى عتبة دارك؟ .. حدثتني نفسي وأنا أتسلّقُ سورَ حديقتكِ أن أنقش لكِ على صفحة القمر كلامًا لم يسبقني إليه الأقدمون وأن أتصوّركِ جميزةً عالية كلما كشفتْ لي عن ثمرها الحلو وظلِّها وعقيقِها كشفتُ لها عن مائي! آهِ.
لو كنتُ أعلم أنكِ ابنة الكاهن الأكبر وأن في عشقكِ يأسي لتريثتُ قليلًا أظنني كنتُ سأخطط للأمر، ساعتها، على مهلٍ ولا أندفع خلفكِ هكذا كــإوزةٍ تمضي ، فاردةً جناحيها، إلى شَرَكِها المنصوب لعلّني كنتُ سأصحو من نومي هانئًا وأقابل تباشير الصبحِ بلا غصّةٍ فلا الحلق يمتلئ مرارةً وأنا أرى أعوان أبيك وهم يضعون الكِلسَ في عينيَّ ولا الحزن يفلّني إذ ترسن عكّازتي خَطوي لعلّني كنتُ سأفرح بهذه الأنغام السابحة في مداري وأخِفُّ بها دهرًا وتخِفُّ بي وأحسبُ أنني.. ما كنتُ سأنفق ما تبقى من العمر وأنا أعمى أنتهزُ الفرصةَ وراء الفرصة لأقف فوق الروابي العاليات وأجدّفُ بين الناس طويلًا على الكهنة والآلهة! وكان الكِلس أبيض وكان وجهكِ أبيض في حياة أخرى كنت فخّاريًا أقف لساعات وساعات أمام دولابي المنصوب وأشكّل من الطين، داخل فنائي الرحب، صِحافًا ودوارقَ ومسارج تعلّمتُ أن أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله ومع ذلك لم أسلم من جبروت الجند هؤلاء الذين يختالون فوق الأحصنة المُسرجة وينهبون خير بلادنا ليلَ نهار لهذا السبب وحده عقدتُ العزم على السفر واثقًا أن باب الرزق واسع وأن الربَّ هنا ربُّ هناك فأغلقتُ بوابة البيت وحملت عُدّتي ومتاعي قاصدًا تخوم (الإسكندرية). في الطريق كان المسافرون يلهجون بغرائبَ لا تحصى عن تلك المدينة أما أنا فَبِتُّ أفكّر في غرين أجولتي إلام سيحتمل فحيح الرمل؟! وكيف سينجو من هرطقات الرخام؟! ... ....... لا تقولي شيئًا انتظري قليلًا يا كَرمتي! ودعيني أتذكّر ما الذي جرى حتى يندهني "مار مينا العجائبي" كيما أسكن بجواره؟! ومتى انتقلتُ إليه راضياً، مُسلِّمًا وأحببتُ ، في أشهر معدودات، صحراءه القاحلة؟! ... وَيْ! ........ وَيْ! .. ها أنا أصنع قارورةً وأرسم على وجهها جملين جاثمين جاعلًا القديس الشهيد واقفًا بينهما وهو يرفع كفّيه إلى السماء ألم أهدك إياها ساعة نزولكِ مع الحجيج لتشربي منها دونما ثمن؟! ألم أترصدكِ طوال فترة الزيارة لأحدثكِ عن سهمكِ الذي دوّمتْ ريُحه في بهو قلبي ألم أقل لكِ وأنتِ جالسة عند ماء الينابيع: لنعش معًا وليكن الحبُّ خبزَنا وكفافَ يومنا لنجعل مواسم الدنيا ربيعًا أخضرَ لا تصديني كي لا تصبح قدماي ، في الدرب، باردتين لا تصديني فحتمًا ستملأ الوحدةُ دمي بالزوابع إن فعلتِ انسكبي فوقي غيمةً ودعي ماءكِ يوشوش أعضائي ويتلألأ بالبشارة وأسرار الملكوت اغسلي صدري جيدًا ليتعلّم الحكمة والأمثال علّه يكرز باسمكِ وبتلك الشريعة المنسيّة! قاسميني الأرض.. كلَّ الأرض قاسميني الحياة. ولمّا أومأتِ بالموافقة كنتُ قد انتويتُ بناء منزلٍ جديدٍ يكون وسط مدينتكِ الكبرى فيتسنى لكِ رؤية البحر وقتما تحبّين وها أنذا أرجع إلى بلدتي عبر النيل المبارك وحاجتي أن أبيع البيتَ القديم لأؤسس بثمنه عُشَّنا يخيل إليّ أن شراعَ السفينةِ صفحةٌ بيضاء وأن يدي تخطُّ ، فجأةً، ما لا تقدر عليه والنسيم يحمل أشواقي راغبًا إليكِ وفيما كنتُ منتشيًا بقُبلاتكِ التي سيطير صداها في هيكلي كَــرنّاتِ النواقيس ولمستكِ وهي تصير ، من أجلي، زيتونًا وحنطةً ونبيذا رأيتُ الفيضان قادمًا بعزم قوته يدكُّ القرى ويقتلع النخلات العاليات وكان الموج أبيض وكان وجهكِ أبيض حلا لي أن أجعل من كَفّيَّ بوقًا وأنادي ، بصوتٍ ريّان، على بضاعتي حلا لي أن يشدَّ الأطفال عباءات أمهاتهم الـمـُوريات؛ ليتوقفن قليلًا أمام حانوتي ريثما يشترون علائقي. أنا الحلوانيّ أمضيتُ زمنًا _ يا بنة الحسبِ والنسب_ وأنا أصنع من السُكّرِ المعقودِ دُمًى حتى أبوح باسمكِ دون رهبة أو خوف فكنتُ أرصُّ على طاولتي إذا ما هزَّ الليلُ أقاصيَّ عرائسَ وغزالاتٍ وأفراسًا وقبل أن تجفَّ بطونُها أكون قد طعَّمتُها بخرزاتٍ مُلوّنةٍ، ترفع ياءكِ طائعةً والـ ... ..... ميم ..... ............ هكذا إذن انتظرتُكِ هناك أملًا في الملاطفة والوصال وظللتُ أُمنّي ليلتي بساعة أُنسٍ وأقول: ستأتي على رسلكَ، فلا تجزع وسيحقُّ لكَ أن تقرع سماواتها بكلتا يديك وترجم بأنجمها السهرانة وساوسكَ إذا أطلّتْ، فوق أَهِلَّةِ صدرِها، كالشياطين المردة وتأخذك الغبطةُ لا لأنكَ راقبتَ الكهرمانات واليواقيت والألماسات يلتمعن على رَملة الفخذين أو رأيتَ الضوء يحاجج الماء في جنات بطنها وإنما لأنها أشفقتْ بكَ وقبل أن تغمركَ بكنوزها وأثقالها وتضربكَ بالرّجة والزلزلة أرتْكَ الرضا يتنزّل رويدًا رويدًا ثم يتكئ على عرش سُرَّتها الوطيد الرضا الذي لطالما عَدَّته روحك، في شريعتها، إمامًا غائبًا لكن.. لِمَ لمْ تأتِ يا فُسْطاط العذوبة وقاهرة بروج الأبجدية؟! ...... .......... أوّاه! لقد كنتِ على ناصية الحارة إذن تلوكين الحسرةَ والدمعُ يستوقد تحت نقابكِ دمعًا وكان بصّاصو زوجكِ ذاك (الشريف) المُحتسِب ينشرون قُلُوع المكيدة في الظلام وأنا غير آبهٍ بزفير الجهات_ رحتُ أحلم بأحصنة الرغبة وهي مدفوعة بدغدغة لساني فإذا بها ترمـح مما بين النهدين حتى نحاس الفرْجِ المُكفَّتِ لكأنّي أردتُ ، لحظتها، أن أسترجع بـرِيقي وأنفاسي وقعَ خطواتكِ وأنتِ مُقبلة عليَّ من بين القصرين إلى باب "زويلة" الكبير! وكان السيف أبيض وكان وجهكِ أبيض لا أثملُ إلا لأُلجم مهرةً خضراء ترتع بين زجاج الإناء والخمر بين دغل القصب والموسيقا بين الرباب والتراب لا أزرع إلا لأُسرّح البصر في هاته الأرض أنّى لها أن تقدّم وردها جاماتٍ وأكْؤُسًا فتصبَّ لها البلابل والحساسين ما يشفي غُلَّتها؟! وأرقص لأفلتَ ، بعض الوقت، من جسدي لأعانق صفوة الملائكِ وجواهر الأفلاك وأرى نسغَ النقطةِ وهو يسيل ، فَـوَّارًا، على لحاء المحيط! ها هي ذي يمناي مرفوعة باتجاه الحــقِّ وراحة اليسرى ممدودة تظلل رؤوس الخلائقِ والعباد أطَّوَّف أدور وأعلو قابضًا على لا شيء! ناثرًا كل شيء .. في التكِيَّةِ كانت يدكِ تتبدّى من خلف الأفاريز والجمعُ كلُّه منشرحٌ بالذكرِ والسماع وأنا فَرِحٌ بهذه اليد أُحِسُّ بها عندما يستعر الدوران تحطُّ على صدري فتقيم العدل هـهنا وتستروح أناملُها معي ذكرى خلافة راشدة! أدبدبُ بقدمي شاقّـاً حَرِيرة الإيقاع_ فينبئني رنينُ أساوركِ بحديثٍ متواترٍ عن خاتمها أدبدبُ فتصحو أصابعُها نابضةً لتحمحمَ ، تارةً، في الهواء وتارةً لتعجن صفائحَ الخشبِ بصهيلها الجذلان أدبدبُ فــيطير النَّقْعُ يصير العالمُ تحتي لجّةً أغوصُ فيصير العالمُ بستانًا أشِفُّ أرِفُّ وأرتقي ** الخلوة رهان العارف فلولاها لما عاقر السرَّ وأَنَس ولما مَلَكَ بما لا يملك لذا جعلتُ أستجير بيدكِ كلما أناختِ الوحشةُ طعناتِها في مرابضي وأخذتُ أرددُ أصابعَها الخمسةَ وِردًا صدقيني فبالنسبة لي كانت أطرافُ أصابعكِ مفاتح سُورٍ استُهِلَت بالحمد فقرأتُ: (أمَّ الكتاب) و(الكهف) و(سبأ) و(فاطر) وحينما كنتُ أشعرُ بسُلاميّاتها تنام على خدي ويدميني اشتياقي إليكِ كنتُ أجهشُ بالبكاء، مرتجفًا أتدبّر: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ...) ... أيُّنا ألقى شِصَّه في ماء الآخر أولًا أنا أم أنتِ؟! .. كنت أرقص وأخال جلابيب الدراويشِ حولي غيماتٍ بيضًا أخال الموسيقى حِبرًا وقدمي يراعًا فأكتبُ أمامكِ دَابًّا: (جسم خاک از عشق بر افلاک شد کوه در رقص آمد و چالاک شد)* توهّمتُ من فرط اللذة يا زوّادة الأعالي_ أنكِ ، لوهلةٍ، تمددتِ قُدّامي وأنكِ أمسيتِ أرضًا تستوجب المسرى توهّمتُ أنني عِفتُ لبنَ المراضع وأنني رعيتُ ، بين شعابكِ، غنمات صهري حِججًا وفي طواكِ ألقيتُ عصاي فإذا هي حَيّةٌ وسمعتُ ، فوق طوركِ، كلامَ اللهِ كـَجرِّ السلاسل! توهّمتُ... لكنني سقطتُ ، في النهاية، هلعًا وعلى فمي آثارُ زبدٍ كثيف يومذاك لمحتُ ، فيما أنازع رُسُلَ مَنِيَّتي، خِضابَ يدكِ وما بين الزبد والحناء شاهدتُ ألف ألف فراشة وهي تؤبر نار الشموع! وكان النور أبيض وكان وجهكِ أبيض الآن أجلس إلى طاولتي أُقلّبُ جلودي أو جلود طرائدي كأيّ صيّاد حجريّ أمتحنُ حَلّاجي الزمن بأقْطَان الماضي وأضحــــك فلا يزال الورق أبيض ووجهكِ أبيض وأعرف أنني سأضيع بينهما وأخبو كصفير الرياح في العتمة كــالـعتمة لكن.. ما لا أفهمه حقًّا لماذا كُتِبَ عليَّ في كل حياةٍ عشتها أن يغيّبني الموت بينما أكون حالمًا بالهواء الكائن بين ذراعيكِ الهواء الرحيم الذي تمنيتُ ، دومًا، أن يكشف عن قلبي الخرائبَ والمنافي والأسفار ... مهٍ مهٍ يا حبيبتي لماذا يغيّبني الموتُ قبل أن تطـأني رجفةُ اليقينِ في حضنك.
لقد علا الجسدُ الترابيّ ، بفعل العشق، حتى وصل إلى الذرى والأفلاك وكأني بهذا الجبل يرقص ويخِف. (مولانا جلال الدين الرومي). _مثنوى معنوى).