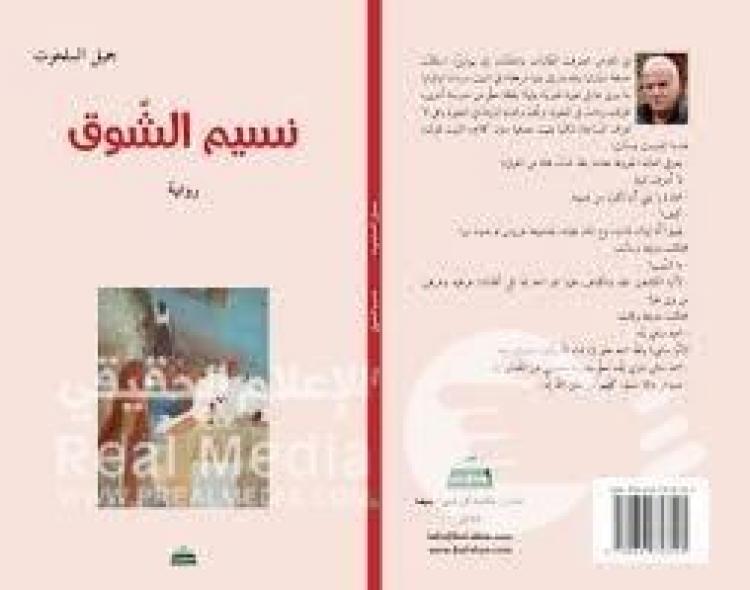رانية مرجية:
قراءة نقدية–فلسفية في كسر قيود الطائفية الدينية أولا: التأسيس الجمالي — من الرواية الواقعية إلى الرواية الكونية. لا يمكن قراءة «نسيم الشوق» ضمن حدود الواقعية الفلسطينية وحدها، لأنها تتجاوزها إلى أفقٍ أوسع؛ أفق الرواية الكونية التي تجعل من التجربة الفردية — تجربة الأسير، تجربة العاشق، تجربة المختلف — صورة للإنسان في صراعه الأزلي مع القيود. جميل السلحوت لا يكتب عن السجن كجدران، بل كوعي محاصر. الأسير الخارج من القيد في الرواية ليس بطلا بطوليا بل كائن ميتافيزيقي يبحث عن معنى للحرية في عالم يضيق بالإنسان أكثر من زنزانة. وهنا تتحول فلسطين في النص من جغرافيا إلى رمز للوجود المقموع. فكما تُسجن الأرض خلف الجدار، يُسجن القلب خلف الطائفة. وكما يُحتلّ المكان، يُحتلّ الوعي باسم الدين والعُرف. إن هذا التداخل بين الخارج والداخل، بين الجدار والضمير، يصنع من الرواية بيانا فلسفيا ضدّ كل أشكال الاحتلال: احتلال الأرض، واحتلال الروح، واحتلال المحبة. ثانيا: فلسفة الحبّ في مواجهة اللاهوت المغلق في «نسيم الشوق»، الحبّ ليس نزوةً بشرية بل لاهوت بديل لاهوت الأرض لا السماء، لاهوت الإنسان لا المعبد. حين يضع السلحوت أمامنا مسلما يتزوج مسيحية، ومسيحيا يتزوج مسلمة، فهو لا يبحث عن الإثارة الاجتماعية، بل يصوغ لاهوتا جديدا للمقاومة: مقاومة الكراهية بالمحبة، ومقاومة الانغلاق بالانفتاح. في هذا الحبّ، لا يتنافى الإيمان مع الاختلاف، بل يتطهّر به. فالإيمان الحقيقي عند السلحوت لا يُقاس بما نحمل من شعارات، بل بما نحمل من قلوب. «الحبّ هنا ليس ضدّ الدين، بل هو كشفٌ لجوهره المنسي: أن الدين وُجد ليقرّب الإنسان من أخيه الإنسان، لا ليقسمه.» بهذا المعنى، يتحول الحبّ بين المختلفين دينيا إلى ثورة صامتة ثورة لا ترفع السلاح، لكنها تهدم الأسوار بيدين من ضوء. ثالثا: كسر قيود الطائفية — الثورة الناعمة يقدّم جميل السلحوت مفهوما جديدا للثورة: الثورة التي لا ترفع شعار الدم، بل شعار الوعي. فالطائفية، في رؤيته، ليست خلافا عقائديا بل شكلٌ آخر من أشكال الاستعمار. إنها استعمار داخليّ يرسّخ التجزئة في الوجدان، ويحوّل الإيمان إلى هوية قاتلة بدل أن يكون خلاصا مشتركا. الرواية تُفكّك هذه البنية بهدوء فنيّ، دون خطابة، عبر الحياة اليومية نفسها: في الحوار بين المسلم والمسيحي، في العلاقات العائلية، في لغة التسامح التي تخرق صمت المجتمع، في زواجٍ يجمع المختلفين ليصبح مرآة للوطن الذي يُراد له أن يبقى ممزقًا. والسلحوت لا يهاجم الأديان، بل يطهّرها من التعصّب. إنه لا يرفض الانتماء، بل يرفض تحويل الانتماء إلى قيدٍ روحيّ. فالمسيحية والإسلام في الرواية وجهان لإنسان واحد: الإنسان الباحث عن الله في الآخر، لا ضده. رابعا: المرأة كجسر ميتافيزيقي بين الأديان المرأة في الرواية لا تُقاس بأنوثتها الجسدية، بل بأنوثتها الكونية. إنها الرحم الذي يوحّد المختلفين، الجسر الذي يعبر عليه الإنسان من الدين إلى الإنسانية، من الخوف إلى الحبّ، من الانغلاق إلى الحرية. المرأة المسلمة التي تحبّ المسيحي لا تخون تقاليدها، بل تستعيد المعنى الأصيل للعشق، العشق بوصفه حالة كشفٍ روحيّ، تحرّر من عبودية الإسم والهوية. وكذلك المرأة المسيحية التي تتزوج المسلم لا “تتجاوز العقيدة”، بل تفتحها على معناها الإنساني الأوسع. الأنثى في «نسيم الشوق» هي الأنثى–الرمز: رمز الأرض التي لا تفرّق بين من يزرعها. ورمز الإلهة الأم التي تحتضن الجميع دون سؤال عن الطائفة. بهذا، تتحول المرأة إلى صوت النبوّة الإنسانية داخل الرواية، صوت الرحمة في وجه عالمٍ يقدّس الذكور والنصوص وينسى الحبّ. خامسا: السجن كرمز للوعي الأسير. السجن في الرواية ليس مجرد مكان للعقوبة، بل مرآة لواقع أوسع: كل شخصية تحمل سجنها في داخلها. سجن الدين المغلق، سجن التقاليد، سجن الخوف من المجتمع، سجن الانتماء الضيق. وعندما يخرج سهيل من السجن، يكتشف أن الحرية ليست في الهواء بل في الوعي. إنه يخرج من الأسر الماديّ ليصطدم بأسرٍ أشدّ قسوة: نظرة الناس، قيود الشرف، الخوف من المختلف، وسلطة الطائفة. “لقد خرجت من سجن الاحتلال، لكنني لم أخرج من سجن الناس.” بهذا المعنى، الرواية كلها هي رحلة خروج من الظلّ إلى النور. سادسا: جماليات اللغة والرمز. لغة السلحوت في الرواية بسيطة، لكنها تخفي عمقا صوفيا. فهي لغة “العاديّ الذي يلمس المطلق”، حيث الأشياء اليومية الزيتون، النسيم، التراب، الجرس، الآذان — تتحول إلى رموز للتمازج الروحي. الزيتون رمز للثبات والسلام، يربط الفلسطيني بالمقدّس الأرضي. النسيم في العنوان يرمز إلى الحرية الخفيفة التي تدخل من الشقوق الضيقة، كأنها رسالة من الله إلى الإنسان. الصلاة والجرس يلتقيان في الفضاء السمعي للرواية، ليشكّلا نشيدًا واحدًا ضدّ الصمت الطائفي. اللغة عند السلحوت ليست أداة نقل، بل فضاء توحيد؛ كل جملة فيها تُبنى على التوازي لا على التناقض. 🔷 سابعا: المقاومة الكونية — من فلسطين إلى الإنسان في «نسيم الشوق»، تتحرّر فلسطين من خصوصيتها لتصبح رمزا للإنسان في كلّ مكان. الكاتب يُعيد تعريف المقاومة لتشمل مقاومة الجهل والكراهية والتعصّب، فيرتقي من الخطاب الوطني إلى الخطاب الكوني الذي يرى في المحبة خلاصا للبشرية كلها. فالوطن لا يُحرَّر فقط من العدوّ الخارجي، بل من الكراهية التي تزرعها الأديان حين تفقد جوهرها. بهذا، يتقاطع فكر السلحوت مع رموز أدبية كبرى: مع تولستوي في إنسانيته، وغسان كنفاني في واقعيته الثورية، وإلياس خوري في انفتاحه على التعدّد. لكن السلحوت يضيف إليهم بُعدًا فريدًا: المصالحة الروحية بين الإيمان والعقل، بين الحبّ والمقاومة. ثامنا: الخاتمة — رواية الإنسان الكامل «نسيم الشوق» ليست رواية شخص، بل سيرة وعي جماعيّ. هي رواية الإنسان حين يتحوّل من مؤمن بالطائفة إلى مؤمن بالإنسان. حين يدرك أن الله لا يقف على جانبٍ من الحدود. بل في قلب من يحبّ رغم الاختلاف. إن أجمل ما في الرواية أنها لا تنتهي، لأنها تترك في القارئ سؤالًا مفتوحا: هل نقدر نحن — أبناء اليوم — أن نحبّ كما أحبّ أبطالها؟ أن نكسر قيود الدين كما كسروا؟ أن نؤمن بالإنسان كما آمن جميل السلحوت؟ 12-10-2025