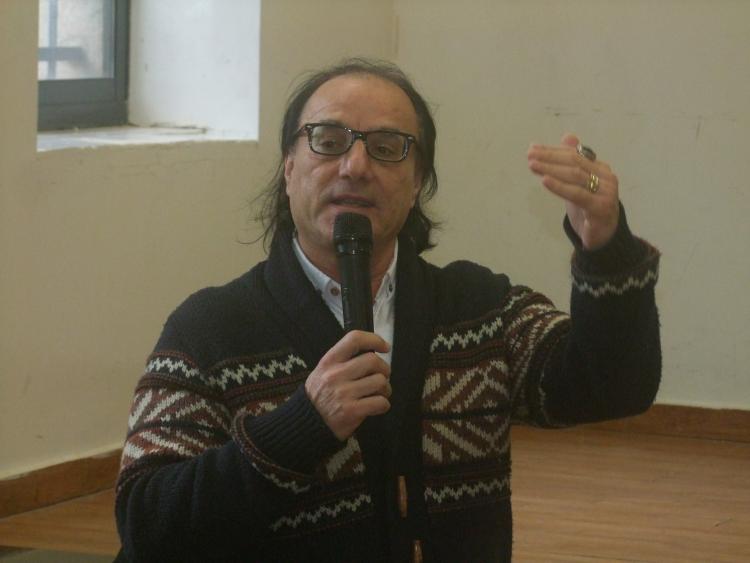بقلم: أ. سامي قرّه
مقدّمة
القدس مدينة ذات جذور تاريخية عميقة، تحمل دلالات روحية وثقافية غنية، وتعد مركزًا فريدًا للديانات السماوية الثلاث. عبر العصور، كانت مهدًا لحضارات متعاقبة ومسرحًا لصراعات سياسية طويلة الأمد، ما جعلها رمزًا للتنوع الثقافي وملتقى لتداخل أبعاد الهوية، وتجسيدًا حيًا لصراع مستمر حول الأرض والانتماء والسيادة. على الرغم من أن الأجيال الفلسطينية الأكبر سنًا في القدس تملك ذكريات حيّة وراسخة عن مدينة كانت امتدادًا طبيعيًا لهويتهم الثقافية والوطنية، إلا أن الشباب الفلسطيني المعاصر يعيش في ظل واقع مغاير تمامًا، يعكس تحوّلات بنيوية عميقة على مستويات متعدّدة. فمن الناحية الجغرافية، يتعرض هؤلاء الشباب لتغيرات مستمرة في بنية المدينة، نتيجة لسياسات متعمدة تهدف إلى إعادة تشكيل التركيبة السكانية والجغرافية للقدس، عبر عمليات الاستيطان، وهدم البيوت، وسحب الهويات، ومنع لمّ الشمل، والقيود المفروضة على حرية الحركة، وغيرها من الإجراءات التي تسعى إلى تقليص عدد السكان الفلسطينيين في المدينة. هذه الإجراءات تفرض قيودًا شديدة على تنقل الفلسطينيين داخل المدينة المقدّسة، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم في الوصول إلى أماكنهم الأصلية والاحتفاظ بعلاقتهم المادية والرمزية مع المدينة. أمّا على الصعيد الثقافي، فثمة تأثيرات خارجية عديدة، خاصة من الثقافة الإسرائيلية والغربية، تتسلل بقوة إلى نسيج المجتمع الفلسطيني المقدسي، مما يسهم في تآكل تدريجي للتراث والعادات والتقاليد الفلسطينية الأصيلة. تتجلى هذه التأثيرات في ممارسات الحياة اليومية، والأنماط الاجتماعية، والاحتفالات الشعبية، وطرق التعبير الفني والثقافي. يؤدي هذا التداخل الثقافي غير المتكافئ إلى شعور الشباب المقدسي بحالة من الاغتراب الثقافي، تختلف عمّا يعيشه أقرانهم في الضفة الغربية. فهم يجدون أنفسهم في صراع دائم بين الحفاظ على جذورهم وهوّيتهم الفلسطينية، وبين التكيّف مع واقع ثقافي مغاير يفرضه الاحتكاك اليومي بالمجتمع الإسرائيلي وتأثيرات الثقافة الغربية. أمّا على الصعيد اللغوي، فتشهد بيئة اللغة لدى الشباب تغيّرات عميقة، حيث تتراجع مكانة اللغة العربية كلغة أم وركيزة أساسية للهوّية الثقافية، في ظل تزايد استخدام اللغة العبرية في مجالات مختلفة مثل التعليم في المدارس والجامعات، وسوق العمل، والمرافق العامة. هذا التراجع التدريجي في استخدام اللغة العربية لا يقتصر تأثيره على ضعف مهارات التعبير اللغوي فحسب، بل يمتد ليهدّد تماسك الهوّية الوطنية، نظرًا لأن اللغة تُعدّ عنصرًا محوريًا في تشكيل الذاكرة الجمعية والحفاظ على التراث الثقافي. يتجسّد الاغتراب اللغوي الذي يواجه الشباب الفلسطيني في القدس في صعوبات التواصل مع الأجيال الأكبر سنًا، وفي فقدان مفردات وعبارات تمثل ثقافتهم الشعبية، بالإضافة إلى شعور متزايد بالانفصال عن بيئتهم الأصلية. تتداخل هذه التحوّلات الجغرافية والثقافية واللغوية وتُسفر عن حالة اغتراب متعدّدة الأبعاد، تعمّق الشعور بالتهميش والانعزال لدى الشباب الفلسطيني في القدس، وتُضعف ارتباطهم بهوّيتهم الأصلية وارتباطهم الوثيق بمدينتهم التاريخية. كما أن هذا التباعد لا يؤدي فقط إلى خلق فجوة بين الأجيال، بل يشكّل أيضًا تهديدًا بنيويًا لمنظومة الهوّية الفلسطينية نفسها، ويقوّض أسس الصمود الثقافي والاجتماعي في وجه محاولات الطمس والتغيير القسري. بالتالي، لا يمكن النظر إلى هذه الظاهرة على أنها مجرد أثر جانبي لعمليات التحديث أو التطوّر العمراني، بل هي جزء من نهج مقصود يعمل على إعادة تعريف هوّية الإنسان المقدسي، عبر فرض سرديات ثقافية وسياسية مهيمنة تُقصي الآخر وتعيد تشكيل الحيّز الرمزي والثقافي والاجتماعي في المدينة. إن مواجهة هذه التحدّيات تتطلب معرفة ثاقبة لطبيعة هذا الاغتراب المعقد، وإعادة التفكير في استراتيجيات دعم الشباب الفلسطيني، عبر تعزيز مؤسسات التعليم والأنشطة الثقافية والمبادرات المجتمعية التي تكرّس الانتماء والهوّية، وتوفر بدائل تمكّنهم من مقاومة محاولات الطمس والاندماج القسري. ويظل الحفاظ على هذه الهوّية مسؤولية وطنية وأخلاقية، تمس جوهر مستقبل القدس وأهلها، وتدعو إلى جهود متضافرة لإعادة بناء الروابط بين الشباب وذاكرتهم، وبينهم وبين مدينتهم المقدّسة. الاغتراب الجغرافي: اضمحلال المشهد وتعدّد السرديات في مدينةٍ يتشابك فيها الحجر بالتاريخ، والشارع بالأسطورة، لا تسير الحياة اليومية في القدس بمعزل عن سؤال الوجود والهوّية. فالمدينة التي تمشي فوق تلالها الرياح المثقلة بالحكايات ليست كما تبدو على سطح الخرائط الحديثة، بل تُكتب من جديد على إيقاع تغيّر العمران واندثار الذاكرة. بالنسبة للفلسطينيين، وخاصة الجيل الشاب، لم تعد القدس المدينة التي تسكن القلب، بل غدت فضاءً مشوّهًا متغيرًا، يتوارى خلف ستار من الإقصاء الرمزي والتحوّل المادي الذي يمحو ملامحها الأصلية. فالمكان الذي كان يمثّل الامتداد الطبيعي لبيئة الأجداد، بأزقته الضيقة وأشجاره العتيقة وأسواقه المفتوحة، بات اليوم محاصرًا بجدران إسمنتية ونقاط تفتيش وأسماء دخيلة. إنها القدس الجديدة، لا كما يراها أهلها، بل كما فُرضت عليهم. في أحياء مثل بيت حنينا وشعفاط مثلًا، ينشأ جيل جديد محاطًا بجدران إسمنتية وأسلاك شائكة ونقاط تفتيش عسكرية، فتغدو هذه العناصر جزءًا من حياة هذا الجيل الجديد اليومية، لا تُدهش العين ولا تثير التساؤل، بل يتم استيعابها كأنها جزء طبيعي من البيئة الحضرية. بهذا الشكل، ينمو الإحساس بالمدينة لا بوصفها فضاءً فسيحًا مشتركًا، بل كمجموعة من الكتل المنفصلة والمنعزلة، تقطّعت أوصالها وبهتت معالمها. لم تعد القدس كما رواها الأجداد أو كما صوّرتها الذاكرة الجمعية. المدينة التي كانت تنبض بالحياة في أسواقها المفتوحة، وطرقها المتعرجة، وأشجار الزيتون التي تمد جذورها عميقًا في التلال، تحوّلت اليوم إلى مشهد باهت لا يحاكي تلك الصورة التي عاشتها الأجيال السابقة. لم تعد هذه المعالم حاضرة سوى في الذكريات والروايات الشفوية، ومع تلاشيها، ضعفت روابط الانتماء، وتسلل شعور بالاغتراب حتى داخل المكان ذاته. هذا الاغتراب لم يعد مجرد مسألة بعد جغرافي، بل أصبح غربة داخلية، شعورًا متراكمًا يتولّد مع كل صورة جديدة تُفرض على الوعي: لافتات بلغات أجنبية، عمران دخيل لا يمتّ إلى البيئة ولا إلى الهوّية بصلة، ومشهد يومي مفرغ من رموزه التاريخية. لم تعد القدس تُعرف في رموزها الثقافية والتاريخية التي شكّلت هوّية الفلسطينيين لعقود، بل صار حضورها مشروطًا بمظاهر طمس تلك الرموز وتهميش معالمها الأصلية. في قلب المدينة، أعيد تشكيل الفضاء العام ليعكس سردية أحادية تُقصي الرواية الفلسطينية، ويتم الترويج لها في المتنزهات والمراكز الثقافية والمواقع الأثرية من خلال لافتات عبرية وانجليزية (وربما عربية شكلية)، تُقدّم تصورًا مغايرًا لتاريخ المدينة وسكانها الفلسطينيين. وهكذا، تتحوّل القدس من رمز للهوّية إلى مساحة متنازَع عليها، ليس فقط في الجغرافيا، بل في الذاكرة والرؤية واللغة. ويظهر هذا التغييب المتعمّد للهوّية الفلسطينية وطمس المعالم الثقافية والتاريخية بشكل جلي في سياسات إعادة تشكيل الفضاء العمراني، حيث لا يقتصر الأمر على البناء أو الترميم، كما يحدث في مشاريع البنية التحتية، حيث يتم بناء طرق جديدة لتسهيل الحركة وتلبية الاحتياجات المتغيرة، وفي المقابل تُمحى الطرق القديمة التي لم تعد فعالة أو أصبحت تعيق التطور، بل يتعداه إلى محو التاريخ وإعادة كتابة الذاكرة. فلنأخذ على سبيل المثال حيّ ماميلا (مأمن الله)، بالقرب من باب الخليل في القدس، الذي تحوّل اليوم إلى مركز تجاري فاخر يعجّ بالزوار، لكنه قائم فوق أنقاض ما كان في الماضي منطقة فلسطينية عامرة بالحياة تمّ طمس معالمها. ومن الأمثلة الأخرى التي توضح كيفية استخدام إعادة تشكيل الفضاءات العامة في القدس لأغراض سياسية ورمزية، حيث يُعاد إنتاج التاريخ ضمن سردية أحادية تقصي الآخر، مثال حيّ المغاربة الواقع بمحاذاة حائط المبكى أو حائط البراق. فقد كان هذا الحيّ، الذي أُنشئ في القرن الثالث عشر جزءًا أصيلًا من البلدة القديمة، وسكنه فلسطينيون من أصول مغاربية. كان حيّ المغاربة يضم بيوتًا ومدارس ومساجد وزوايا دينية، وكان يعيش فيه مجتمعًا نابضًا بالحياة ومترسخًا في النسيج التاريخي للمدينة. إلا أنّه في 10 حزيران 1967، وبعد يوم واحد فقط من احتلال القدس الشرقية، أقدمت السلطات الإسرائيلية على هدم الحيّ بأكمله خلال 48 ساعة، ما أدّى إلى تهجير نحو 650 من سكانه، بذريعة فتح ساحة واسعة أمام حائط المبكى لتسهيل الصلاة اليهودية. يكشف المؤرخ الفرنسي فنسنت لومير في كتابه " تحت وطأة الحائط: حارة المغاربة في القدس – حياتها وموتها 1187-1967" (2024) أن هذا الهدم لم يكن عفويًا كما تدّعي الرواية الإسرائيلية، بل كان قرارًا رسميًا اتخذته أعلى المستويات السياسية والعسكرية، استنادًا إلى وثائق أرشيفية تثبت أن الإخلاء والطرد نُفّذا بصورة منهجية خلال ساعات قليلة. كما يشير لومير إلى وجود تواطؤ ضمني بين إسرائيل والأردن، تمثّل في صمت عمّان مقابل استمرار وصايتها الدّينية على المسجد الأقصى، الأمر الذي ساهم في طمس الوجود المغاربي التاريخي في القدس. واليوم، لم يبق في الموقع أي إشارة إلى تاريخ الحيّ أو أهله، إذ تحوّل الفضاء إلى ساحة تُقدَّم ضمن سردية إسرائيلية خالصة تركّز على الرمزية الدّينية اليهودية، في تغييب تام للذاكرة الفلسطينية. هذه السياسات لا تغيّر المدينة فقط، بل تعيد تشكيل علاقة الإنسان بها. فعندما تنمو الأجيال الجديدة في بيئات خالية من العلامات التي شكّلت هوّية المكان، تُصبح العلاقة بين الفرد والمكان هشّة ومضطربة. الشاب الذي يسكن حيًا لم تعد تسميته تعني له شيئًا، ولم يعد يضم أي أثر لذاكرة أهله، يشعر وكأن المكان يُسحب منه تدريجيًا. وقد أدى ذلك إلى تغيّرات ملموسة على الأرض؛ يبيّن تقرير صادر باللغة الإنجليزية عن منظمة "بتسيلم" للعام 2019 أنّ معدّل هدم المنازل في القدس الشرقية قد تضاعف بذريعة البناء "غير المرخّص"، في إطار منظومة تخطيط ممنهجة تتجاهل عمدًا الحقّ الطبيعي للفلسطينيين في النمو والتوسّع العمراني. ووفقًا للتقرير، فقد هدمت السلطات الإسرائيلية بين عام 2004 ونهاية عام 2019 ما مجموعه 978 منزلًا فلسطينيًا، مخلّفة وراءها تهجيرًا قسريًا لـ 3,177 إنسانًا، بينهم 1,710 طفلًا، في مشهد يعكس سياسة اقتلاع متواصلة، حيث لا يزال شبح الهدم يخيّم على عشرات الآلاف من المنازل الأخرى، مهدّدًا استقرار الأسر وحقّها في العيش الكريم على أرضها. لكن هذا التهديد لا يقتصر على الهدم المادي، بل يُفقد السكان، وخصوصًا الشباب، شعورهم بالاستقرار المكاني، ويعزز الإحساس بأن وجودهم في مدينتهم ليس حقًا ثابتًا، بل حالة معلّقة مشروطة قد تُلغى في أية لحظة. بالنسبة للفئة الشابة، فإن هذه التحوّلات لا تُغيّر شكل المدينة فقط، بل تُربك إحساسهم بها كمكان للانتماء. فحين تنشأ في أحياء تكون منازلها عرضة للهدم، ويتم إزالة أسماءها الأصلية، وتغيب عنها المعالم التي تشكّل الذاكرة الجمعية، تشعر بأنك غريب في المدينة التي وُلدت فيها. ويتحوّل الوطن من مساحة احتواء إلى مساحة انتظار مؤقّت. يصف الشاعر الفلسطيني محمد الكرد في مجموعته الشعرية التي نُشرت أصلًا باللغة الإنجليزية بعنوان "رفقة"، هذا العنف الرمزي بوصفه امتدادًا للنكسة الاستعمارية ويقول: "في القدس، تُرسم الخرائط لتنسى وجودنا." تنجم عن هذا الوضع مشاعر تجمع بين القلق والتشتت، إذ يتلاشى الإحساس بالاستقرار، ويحلّ محلّه وعي متنام أن الوجود الفلسطيني في القدس ليس حقًا راسخًا، بل بات وجودًا هشًا، مشروطًا باستمرار الضغوط ومهدّدًا بالإقصاء في أيّ لحظة. وهذا ما يجعل من تجربة الشباب في القدس تجربة اغتراب مزدوج: عن الفضاء، وعن السردية المهيمنة عليه. يُفضي هذا التباين إلى نشوء رؤيتين تاريخيتين لمدينة القدس: الأولى، تحفظها ذاكرة الأجيال الأكبر سنًا، وتنبض بالاستمرارية الفلسطينية؛ والثانية، يعيشها الشباب، مشوّهةً بفعل التخطيط العمراني الجديد والواقع السياسي القسري. وفي معظم الأحيان، يرث الجيل الجديد ذاكرة مبتورة لا تستند إلى تجربة معيشية مباشرة، بل إلى روايات وسرديات منقولة، أو صور، أو حكايات شفوية—مما يعمّق لديهم الشعور النفسي بالانفصال عن المدينة التي يُفترض أن تكون أقرب مكان إلى قلوبهم. في القدس، لا تدور المعركة فقط حول السيادة أو البناء، بل حول من يملك الحق في أن يروي القصة. ومن دون ذاكرة معترف بها، يصبح الشباب الفلسطينيين غرباء في المدينة التي وُلدوا فيها. التغلغل الثقافي وتآكل الهوية: الشباب الفلسطيني في القدس أمام تحدّيات يومية أدّى القرب الجغرافي من القدس الغربية وانتشار المؤسسات الإسرائيلية والثقافة الاستهلاكية الغربية إلى إدخال أنماط سلوكية ومعايير جديدة إلى حياة الشباب الفلسطيني، تبدو في كثير من الأحيان غريبة عن سياقهم الثقافي والاجتماعي. ورغم أن التبادل الثقافي يُعدّ في كثير من الأحيان عاملًا يُغني التجارب الإنسانية، إلا أن السياق الفلسطيني، ولا سيما في القدس الشرقية والمناطق المتاخمة للقدس الغربية، يشهد نمطًا غير متكافئ من هذا التبادل، يتّسم بعدم التوازن والهيمنة وغياب الحوار. فالثقافة المهيمنة، التي تمثلها الدولة الإسرائيلية عبر مؤسساتها الرسمية، ونفوذها التعليمي والإعلامي، بالإضافة إلى حضور الثقافة الاستهلاكية الغربية، لا تتيح تفاعلًا حرًا أو متساويًا مع الثقافة الفلسطينية، بل تفرض نفسها تدريجيًا في تفاصيل الحياة اليومية الفلسطينية. يظهر هذا في إعادة تسمية الشوارع، وفي افتتاح مؤسسات تعتمد مناهج عبرية أو غربية، وفي ترويج أساليب حياة لا تتصل بالمرجعيات الفلسطينية التقليدية. لا يقتصر هذا التأثير على البنية المادية للمدينة، بل يمتد إلى الوعي الرمزي والوجداني، حيث يبدأ الجيل الجديد في تبنّي أنماط تفكير واستهلاك تنأى عن هوّيته الأصلية. وفي القدس الشرقية، يعاني الكثير من الشباب من شعور بالانقسام بين لغتين وهوّيتين ونظامين تعليميين، حيث يضطر بعضهم للالتحاق بالمدارس التي تعتمد المنهاج الإسرائيلي لضمان فرص مستقبلية أفضل، ما يعني في المقابل تقليص تواصلهم تدريجيًا مع الرواية الفلسطينية وضعف ارتباطهم بالتراث الثقافي الفلسطيني. هذا التكيّف ليس اختيارًا حرًّا، بل نتيجة ضغط مستمر من بنية سلطوية تعيد تشكيل الهوّية بشكل غير مرئي لكنه فعّال. في هذا السياق، يتزايد اعتماد الشباب المقدسي على مؤسسات التعليم العالي والخدمات الإسرائيلية. يشير تقرير باللغة الإنجليزية نشرته وزارة القدس والتراث الإسرائيلية بأن 51% من مدارس القدس الشرقية الرسمية تعتمد المنهاج الإسرائيلي. كما يشير تقرير أعدته آلاء ماجد بعنوان "دراسة اللغة العبرية شرق القدس: اتجاه جديد نحو المستقبل" (2025) إلى تصاعد ملحوظ في إقبال طلاب شرق القدس، خصوصاً المرحلة الثانوية، على تعلم اللغة العبرية، كخيار استراتيجي لدخول مؤسسات التعليم العالي والمشاركة في سوق العمل، مما يشكّل تحولًا تدريجيًا نحو منظومة معرفية مغايرة للهوية الوطنية. يواجه الشباب الفلسطيني في القدس تأثيرات ثقافية متداخلة، تنعكس في أنماط الترفيه واللباس والموسيقى والسلوك الاجتماعي، وتُصبح جزءًا من حياتهم اليومية. وبسبب القرب الجغرافي والاحتكاك المستمر مع الفضاء الإسرائيلي، تتسلل هذه التأثيرات تدريجيًا إلى تكوينهم النفسي والثقافي. ليس من غير المألوف أن نشاهد ميل بعض الشباب نحو الموسيقى الإسرائيلية المعاصرة، أو ارتياد مقاهٍ تحمل قوائم طعام عبرية، أو ارتداء أزياء تقترب في نمطها من الحياة في تل أبيب. لا تعبّر هذه الظواهر بالضرورة عن انجذاب طوعي إلى الثقافة الغربية بقدر ما تعبّر عن انفتاح قسري على نموذج ثقافي مهيمن، قد يبدو في ظاهره حداثيًا، لكنه يُضعف البنية الرمزية للهوية الفلسطينية. هذا التفاعل غير المتوازن لا ينتج تبادلًا ثقافيًا صحيًا، بل يُكرّس نوعًا من الهيمنة الناعمة، تُعيد تشكيل الميل الثقافي والمعايير الجمالية والسلوكية لدى الشباب، في ظل غياب مؤسسات فلسطينية قوية قادرة على تقديم بدائل. وفي كثير من الأحيان، ما يبدو خيارًا فرديًا أو انفتاحًا على العالم الخارجي، قد يخفي في طياته فقدانًا تدريجيًا للانتماء وتآكلًا في أسس الهوّية الثقافية الفلسطينية، خاصة حين يغيب الوعي النقدي والبدائل الثقافية الأصيلة. ورغم أن التعبير الظاهري عن الهوّية، مثل الملابس أو الموسيقى، يبقى أمرًا شخصيًا وقابلًا للتغيير، إلا أن هذه التغيرات الخارجية تُشير إلى انفصال أعمق وأكبر عن العالم الثقافي الذي عاش فيه آباؤهم أو أجدادهم. هذا الانفصال يعكس تحولات جذرية في الانتماء والهوّية، حيث يواجه الجيل الجديد تحدّيات في الحفاظ على التراث الثقافي وسط تأثيرات ثقافية متجددة ومهيمنة، خاصة في ظل الظروف السياسية والاجتماعية التي يعيشها. لذا، فإن ما يبدو تغيّرًا سطحيًا في المظاهر، هو في الحقيقة تعبير عن أزمة أعمق في العلاقة بين الأجيال والثقافة الأصلية، ما يطرح تساؤلات حول كيفية صون الهوّية الوطنية في ظل هذه الضغوط المتزايدة. في روايته الذاتية "راقصون عرب" (2011)، التي كُتبت أصلًا باللغة العبرية وتُرجمت إلى العربية وصَدرت عام 2011، يُجسّد الكاتب والصحفي سيد قشوع هذا التوتر الثقافي. يروي قشوع قصة مراهق فلسطيني يدرس في مدرسة داخلية إسرائيلية نخبوية. تعكس الرواية تجربة اغتراب مضاعف: بين بيئة فلسطينية لم يعد ينتمي إليها، ومجتمع إسرائيلي لا يقبله بالكامل. ويكتب قشوع في مقال وداعي نشره باللغة الإنجليزية في صحيفة هآرتس (2014) "لقد خسرتُ حربي الصغيرة... لم أعُد أرى أي أمل في عالم يمكن لأطفالي أن يعيشوا فيه بتعايش بين العرب واليهود الإسرائيليين". هذه الكلمات تلخص شعورًا شائعًا لدى كثير من شباب القدس: إحساس بالتهميش، وفقدان الأمل في إمكانية الانتماء الكامل إلى أي من العالمين. تشير الدراسات الأكاديمية إلى أن هذا الاضطراب في الهوّية الوطنية والثقافية ينبع من التأرجح المستمر بين ثقافتين متباينتين في الجوهر، ما يفاقم حالة الانقسام والصراع الداخلي لدى الفرد. كما تبيّن هذه الدراسات أن الطلاب من القدس الشرقية يعانون من صدمة ثقافية، وحواجز لغوية، وشعور بالانعزال. هذه ليست مجرد اضطرابات عابرة، بل مؤشرات على شرخ عميق في تجربة الانتماء والهوية. في ظل هذه التحوّلات، لم يعد سؤال الهوّية الثقافية أمرًا نظريًا، بل معركة يومية يخوضها الشباب الفلسطيني للحفاظ على ما تبقّى من تراثهم في مدينة تُعاد صياغتها بصمت. ما يبدو أحيانًا تغيّرًا في المظهر أو نمط الحياة، يخفي تحولات جوهرية في المرجعيات الثقافية والانتماء، ويطرح تحدّيات كبرى على الأجيال الجديدة في كيفية صون هويتها في وجه ثقافة مهيمنة تتغلغل بلا مقاومة مؤسسية حقيقية. الاغتراب اللغوي: كبت اللغة العربية يشكل الاغتراب اللغوي أحد أكثر أشكال الاغتراب تأثيرًا في تجربة الشباب الفلسطيني، إذ لا يقتصر على كونه مجرد وسيلة تواصل، بل هو جوهر الهوّية والانتماء الثقافي. فاللغة العربية، الحاضنة الأساسية للتراث الفلسطيني، تتراجع تدريجيًا لصالح اللغة العبرية، خصوصًا بين أوساط الشباب المقدسي، نتيجة التحوّل المتزايد نحو المدارس والمؤسسات التعليمية الإسرائيلية التي تعتمد العبرية لغة رئيسية. حتى في المدارس الفلسطينية، أصبحت العبرية لغة ضرورية لفهم الواقع المعيشي، بدءًا من التنقل عبر وسائل النقل العامة، مرورًا بسوق العمل، ووصولًا إلى التعامل مع المؤسسات الرسمية. وتزداد هذه الديناميكية وضوحًا في التعليم العالي، حيث يلتحق عدد كبير من الطلاب الفلسطينيين بجامعات إسرائيلية التي يقتصر فيها استخدام العربية غالبًا على مواد تعليم اللغة فقط، ما يعمّق حالة الاغتراب اللغوي ويهمّش اللغة العربية تدريجيًا. أظهرت دراسة أكاديمية أجراها الباحث رباح حلبي من الجامعة العبرية حول قضايا الاندماج واللغة والهوية بين الطلاب الفلسطينيين في الجامعة والمعاهد الإسرائيلية أن 70% من الطلاب الفلسطينيين يشعرون بأن بيئة الجامعة لا تعكس هوّيتهم اللغوية والثقافية، ما يعمّق شعورهم بالانعزال داخل الحرم الجامعي ويقلّص من حضور لغتهم الأم في حياتهم اليومية. كما أن البيئة العامة في القدس تشهد انتشارًا متسارعًا للغة العبرية حتى في المحلات التجارية والإعلانات، مما يؤدي تدريجيًا إلى تراجع قدرة الشباب على التعبير الكامل عن أنفسهم بالعربية، ويسهم في بناء وعي لغوي جديد لا يعكس بالضرورة عمقهم الثقافي والتاريخي. هذا الإكراه اللغوي لا يقتصر على الجانب الأكاديمي، بل يحمل تداعيات نفسية واجتماعية عميقة. ففي دراسة استهدفت الطلاب الفلسطينيين في الجامعة العبرية في القدس رصدت الباحثة يارا سعدي-إبراهيم (2021) شعور هؤلاء الطلاب بأنهم مجرد "زوار لا يتركون أثرًا" في فضاء أكاديمي لا يعكس هويتهم اللغوية أو الثقافية تعكس هذه الدراسة تجارب يومية من الانعزال اللغوي والثقافي في الحرم الجامعي. لا يمكن تجاهل البُعد الاقتصادي في تعميق هذه الظاهرة، إذ تدفع الضغوط المعيشية العديد من الشباب الفلسطينيين إلى البحث عن فرص عمل في القدس الغربية أو في مؤسسات إسرائيلية، حيث إتقان العبرية شرط أساسي للقبول والتقدم الوظيفي. ونتيجة لذلك، تتزايد الحاجة إلى استخدام العبرية في الحياة اليومية، خاصة في السياقات المهنية والرسمية، مما يقلّص مساحة اللغة العربية لدى هؤلاء الشباب ويُضعف قدرتهم على التعبير الدقيق عن مشاعرهم وأفكارهم. داخل البيوت الفلسطينية في القدس، يؤدي هذا التحوّل اللغوي إلى فجوات بين الأجيال. فالأجداد الذين يتحدثون العربية فقط يجدون صعوبة في التواصل مع أحفادهم الذين يدمجون العبرية في حديثهم اليومي. وقد تصبح مفردات الشعر العربي الكلاسيكي، والتعابير الاصطلاحية، وحتى الفكاهة التقليدية، غريبة على مسامع الشباب ليس بسبب رفضها، بل لغياب التعرض الكافي لها. هذا الاغتراب لا يعني فقدانًا للمفردات فحسب، بل هو انفصال بطيء عن ثقافة متجذرة بلغتها، بثروتها من الأمثال الشعبية والحكايات الشفوية والتعبيرات الروحية العميقة. تفكّك المجتمع الفلسطيني المقدسي: شباب على مفترق الهوية والاغتراب لا يمكن اختزال حالة الاغتراب التي يعيشها الشباب الفلسطيني في القدس — سواء على الصعيد الجغرافي أو الثقافي أو اللغوي — في مجرد أثر عابر لعملية التحديث أو التطوّر، بل هي نتاج منظومة معقدة تنكر لهم حق الانتماء الكامل، وفي الوقت ذاته تعيد تشكيل هوّيتهم من الداخل. هؤلاء الشباب يكبرون في مدينة تغيرت ملامحها المادية بشكل جذري، حتى باتت غريبة على أجيالهم السابقة، حيث تتآكل تدريجيًا ثقافتهم لصالح الثقافة السائدة، وتواجه لغتهم الأم خطر التراجع إلى مجرد لغة ثانية. تتجلّى التداعيات العميقة لهذه الظاهرة في ازدياد الانفصال بين الشباب وتجارب وقيم ولغة آبائهم وأجدادهم، ما يعزز مخاطر تفكك الهوّية الفلسطينية عبر الأجيال المتعاقبة. في مواجهة هذا التحدّي، يسعى بعض الشباب إلى استعادة هوّيتهم من خلال الانخراط في نشاطات اجتماعية، ومشاريع ثقافية، ومبادرات تعليمية بديلة تُعزّز الانتماء والوعي الوطني. أما آخرون، فيتراجعون بهدوء، مستسلمين لشعور مرير بأن القدس لم تعد لهم، أو ربما لم تكن لهم يومًا. تؤكد الدراسات الحديثة هشاشة هذه الثنائية المتناقضة. يعيش الشباب الفلسطيني في القدس تشتتًا ثقافيًا عميقًا؛ فهم مندمجون اقتصاديًا في المجتمع الإسرائيلي، لكنهم يفتقرون من الناحيتين العاطفية والسياسية إلى الجذور والاستقرار. واقعهم إذًا ليس اندماجًا حقيقيًا، بل اغترابًا مؤلمًا. إن إدراك هذا الاغتراب لا يشكل فقط ضرورة اجتماعية وإنسانية، بل هو واجب أخلاقي حتمي. فإذا أرادت أي رؤية للقدس أن تكون عادلة وشاملة، فلا بد لها أن تبدأ بالاعتراف بالواقع المعيشي لأولئك الأكثر هشاشة: شباب القدس، الذين يقفون اليوم على مفترق طرق بين الضياع والتكيّف، بين الذاكرة والتغيير. في هذا السياق، لا يمكن الحديث عن صمود حقيقي في القدس الشرقية دون الربط بينه وبين الجهود الجادة لبناء مستقبل أكثر عدالة وأملًا لفئة الشباب. إذ لا يقتصر الصمود على التمسك بالمكان أو مقاومة محاولات الطمس فحسب، بل يشمل أيضًا بناء أدوات البقاء الثقافي والنفسي والمعرفي. ومن هنا، يُعتبر إرساء بيئات تعليمية بديلة، وتعزيز المبادرات الثقافية الحيوية، وتهيئة مساحات حوار آمنة، من العناصر الأساسية لمشروع صمود مستقبلي يعيد للشباب صوتهم وثقتهم وهوّيتهم. هؤلاء الشباب لا يعيشون في فراغ، بل يقفون على مفترق طرق بين فقدان الذاكرة وولادة مستقبل لم يتم تحديد ملامحه بعد. وعليه، يُعد إدراك هذه الحالة من الاغتراب ومعالجتها أمرًا لا يقتصر على كونه ضرورة تحليلية فحسب، بل يشكل واجبًا أخلاقيًا وسياسيًا وثقافيًا عاجلًا. فتصور القدس كمدينة عادلة وشاملة لن يكتمل إلا بإعادة الاعتبار لشبابها، بوصفهم حاملي الذاكرة وركيزة المستقبل في آنٍ واحد. الخلاصة تجربة الشباب الفلسطيني في القدس ليست مجرد انعكاس لتغيرات حضرية، بل تعبير عن اغتراب متعدد الأبعاد يمس جوهر الهوية والانتماء. فالتحولات الجغرافية، والتغوّل الثقافي، والتهميش اللغوي تعيد تشكيل العلاقة بين الإنسان والمكان، وتفرغ المدينة من رموزها الفلسطينية. ولمواجهة هذا الواقع، لا يكفي مقاومة السياسات القمعية، بل يلزم مشروع وطني طويل النفس يقوم على تعزيز التعليم البديل والمبادرات الثقافية المحلية، وحماية اللغة العربية وتعزيز استخدامها في المؤسسات التعليمية والحياة اليومية، وتهيئة مساحات حوار آمنة وداعمة للشباب للحفاظ على هويتهم الثقافية والتاريخية. من خلال هذه الجهود، يمكن للشباب الفلسطيني في القدس أن يستعيدوا مكانتهم كحاملي ذاكرة وهوية، ويصبحوا شركاء فاعلين في بناء مستقبل المدينة، بدل أن يكونوا ضحايا واقع مفروض. قائمة المراجع قشوع، س. (2011). راقصون عرب. القاهرة: مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات. لومير، ف. (2024). تحت وطأة الحائط: حارة المغاربة في القدس – حياتها وموتها 1187-1967. (د. تلحمي، مترجم). بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. ماجد، آلاء. (2025). دراسة اللغة العبرية شرق القدس: اتجاه جديد نحو المستقبل!!. أمد للإعلام. https://www.amad.com.ps/ar/post/547629 Bartal, S. (2023). The Palestinian youth of East Jerusalem – between Palestinian and Israeli identity. https://www.researchgate.net/publication/372632191_The_Palestinian_youth_of_East_Jerusalem_-_between_Palestinian_and_Israeli_identity B’Tselem. (2019). 2019 Annual Report. https://www.btselem.org/sites/default/files2/2019_activity_report.pdf El-Kurd, M. (2021). Rifqa. Chicago, IL: Haymarket Books. Halabi, R. (2022). Palestinian students in an Israeli-Hebrew University: obstacles and challenges. Journal of Higher Education. https://www.researchgate.net/publication/363207898_Palestinian_students_in_an_Israeli-Hebrew_University_obstacles_and_challenges Kashua, S. (2014, July 4). Why Sayed Kashua Is Leaving Jerusalem and Never Coming Back. Haaretz. https://www.haaretz.com/2014-07-04/ty-article/.premium/for-sayed-kashua-co-existence-has-failed/0000017f-dbc1-df62-a9ff-dfd7615a0000?utm_source=chatgpt.com Mizel, O. (2020). Degree of Adaptation of Jerusalem Palestinian Students at Israeli Academic colleges. Contemporary Review of the Middle East. https://www.bibliosearch.polimi.it/discovery/fulldisplay/cdi_proquest_journals_2457545241/39PMI_INST:VU1 Sa’di-Ibraheem, Y. (2021). Indigenous Students’ Geographies on the Academic Fortress Campus: Palestinian Students’ Spatial Experiences at the Hebrew University of Jerusalem. Journal of Holy Land and Palestine Studies. https://www.euppublishing.com/doi/abs/10.3366/hlps.2021.0269?utm_source=chatgpt.com&journalCode=hlps Yalon, Y. (2023). Report: 51% of schools in east J'lem use Israeli curriculum.” Israel Hayom. https://www.israelhayom.com/2022/02/25/report-51-of-schools-in-east-jlem-use-israeli-curriculum/